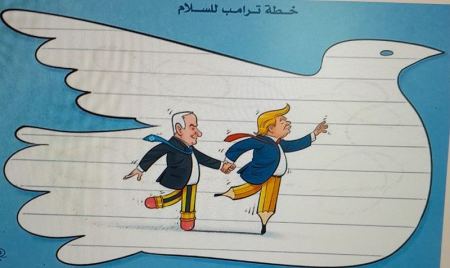كتب جهاد عثمان قبها
كلية الدراسات العليا - جامعة النجاح الوطنية
لم يكن الإرشاد التّربويّ ضمن عناصر المؤسسة التعليمية في العقود السابقة، ذلك أنّ المعلم كان يمارس دوره كمعلم ومربي ومرشد...ومع قدوم السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة كان هناك سعي حثيث على بناء المؤسسات على اختلافها، ومنها: التعليميّة، فقد سعت إلى توزيع الأدوار التّربويّة وتخصيصها بشكل يحقق فائدة أكبر للمؤسسة التّعليميّة بشرائحها كافة، هذا النّهج بدا ظاهرًا منذ بداية الألفية الثّالثة، حيث طرأت متغيرات عديدة على الساحة الفلسطينيّة، من بينها: تداعيات انتفاضة الأقصى على الساحة التّعليميّة في ظلّ خسارة المؤسسة التّعليميّة للعديد من طلابها ومعلميها بين شهيد وجريح وأسير...الأمر الذي أفرز حالة من البحث عن حلول لهذا المشهد، وما يحمل في طياته من تداعيات نفسيّة وسلوكيّة واجتماعيّة...
ولما كانت التّجربة الإرشاديّة حديثة العهد، فإنّها واجهت العديد من التّحديات والمعيقات: ماديةوبشرية، وهذا اتصل في الغالب بضعف الإمكانات، وقلة الجاهزيّة الحقيقيّة التي من شأنها تفعيل دور المرشد بالشكل المناسب، فضلًا عن ضعف التواصل والتّشبيك بين المجتمع المحلي والمدارس، وهذا انعكس بالضرورة على فاعلية المرشد ودوره الهادف إلى بناء جيل قادر على حمل المسؤولية والأمانة والبناء والتنافس والعطاء...، لذا فإنّ رؤية الإرشاد التربوي تقتضي الوقوف على العديد من المسائل الإرشاديّة، التي تلامس واقع العمل الإرشاديّ .
في المدارس الفلسطينيّة وما تواجهه من تحديات ومعيقات قد تحول من نشاط المرشدين وفعاليتهم، ولتحقيق تلك الرؤى أجريت خمس مقابلات مع بعض الأطراف التربويّة لهم باع طويل في العمل الإداريّ والتّعليميّ والإرشاديّ، تناولت فيها: ماهية الإرشاد التّربويّ، وأهدافه، ومعيقاته، ونصائح يمكن الاتكاء عليها لتعزيز قدرات المرشد وكفاياته ومهاراته، كما تم تسليط الضوء على العديد من المشكلات السلوكيّة والانفعاليّة التي يواجهها الطالب في ظلّ التّطورات التكنولوجيّة غير المسبوقة وتطور المشهد الكورونيّ في فلسطين والمنطقة، حيث أشارت العينة إلى وجود العديد من التّحديات التي من بينها: التّطرف في ظاهرتي العنف والتّنمر، وضعف العلاقة بين الأطراف التّربويّة، الأمر الذي ينعكس على العجز المستقبليّ في مواجهة مثل تلك التّحديات، في ظلّ تراكم التحديات المتصلة بخبرات المرشد ومهاراته.
لقد رسمت ملامح المرحلة الممتدة بين عامي 2000-2021 الكثير من التّطورات التكنولوجيّة والمعرفيّة والصحيّة وصولًا لجائحة كورونا، تلك التطورات ألقت بظلالها الثّقيلة على العملية الإرشاديّة؛ انطلاقًا من عدم جاهزيّة المرشد للتعامل مع مثل هذه التطورات، فكانت قلة الخبرات العملية والتطبيقية، وعدم القدرة على مواكبة مثل تلك المستجدات، حتى أنّ هناك فهم خاطئ من قبل بعض المرشدين للرسالة والدور المناط بهم، فيبدو أنهم يتسمون بالانعزاليّة والانطوائيّة، وليس لديهم تلك المبادرات الخلّاقة التي تعزز من دورهم الإرشاديّ.
لا يقف دور المرشد على متابعة الطالب باعتباره محور العملية التّربويّة، بل إنّ دوره يتصل بكافة الشّرائح التّربويّة من: معلمين، وإدارات، وأولياء أمور...فهو ركن أساسي، وقاسم مشترك، ولا يمكن أنّ تحقق النّجاحات المرجوة دون تلك الشّراكة، الأمر الذي يرسخ من إشكالية فهم المرشد للدور المناط به، من قدرة واضحة على التعريف بشخصيته وأداوره، فضلًا عن ضعف الاحتكاك مع تلك الشّرائح المؤثرة في أي نشاط إرشاديّ.
وما يعزز تلك الرسائل ما ذهبت إليه العينة، فقد رأت أنّ الإرشاد ضروريّ ومهم ولا يمكن الاستغناء عنه، وهو بالتالي يواجه تحديات كثيرة منها: ما يتصل بالسرية والخصوصية والغرفة المناسبة، ومنها ما يتصل بخبرات المرشد وشخصيته، ومنها ما يحمل ضعف التّعاون بين الأطراف التربويّة المعنية، في ظلّ أزمة الثقة بالمرشد وما يمكن أن يحققه على الصعيد التّعليميّ والتّحصيليّ والسّلوكيّ...
تلك التّحديات أفرزت مشكلات سلوكيّة وانفعاليّة، كان من أهمها: العنف والتّنمر بجميع أشكالهما، والحساسية الزّائدة وحالة اللامبالاة، فضلًا عن تدني المستوى التحصيليّ؛ الأمر الذي دفع العينة إلى التّأكيد على ضرورة التّدخل السريع لمواجهة مثل تلك المشكلات، التي لا تشكل خطرًا على الطالب والمدرسة فقط، بل إنّ الفشل في علاجها قد يشكل خطرًا على المجتمع، حيث أشار بعض المشاركين إلى أنّ هذا التدخل يحتاج إلى متابعة حقيقيّة، لا سيما أنّه ومن خلال الخبرات والتجارب لم تحل مثل تلك المشكلات بشكل جذريّ، بل حفظت في سجلات، وبقيت حبرًا على ورق، وأكد البعض أنّ الإشكالية هنا تكمن في العلاقة المشحونة بين المدير والمرشد، وعدم توزيع الأدوار بشكل مناسب، وعدم فهم الأطراف التربوية لدور المرشد المكمل لهم.
هذا وقد رأى بعض المشاركين ضرورة تقبل الأطراف التّربويّة للمرشد التّربويّ، وهذا يستلزم وجود كفايات ومهارات من الضروري توافرها في المرشد حتى يتاح له ممارسة الدور بشكل سليم، تلك الكفايات والمهارات تستلزم تدريب مستمر ومواكبة حقيقيّة لكلّ المستجدات والتّطورات، والاقتراب أكثر من الطالب، والاستفادة من خبرات بعض المرشدين المتميزين، وهذا يقتضي تبادل الخبرات وتعزيزها من خلال دعم حقيقيّ من أقسام الإرشاد، والمشرفين والوزارة، كما يستلزم ذلك وجود خطط واقعية وعملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، ووجود برامج تلامس احتياجات الطالب والمرشد والمجتمع، وقد رأى بعض المشاركين أنّ برامج الإرشاد المتصلة بالمراهقة والتوجيه المهني وإن حققت بعض النجاحات، فهي تحتاج إلى الدعم من قبل الأهل، الذين لا زالوا في كثير من الأحيان غير متقبلين لتوجه الأبناء نحو تلك المهن، فهم يبحثون في الغالب عن دور أكبر لأبنائهم في المستقبل، وهذا يعني استمرارهم ضمن التوجه الأكاديميّ، علمًا بأنه من التوجهات التي قد تكون غير مناسبة أو متناسبة مع قدرات الأبناء.
وفي ضوء تلك التّصورات والرؤى التي استندت عليها من خلال استقراء استجابات العينة، فقد قدمت العديد من الاستراتيجيات والحلول التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز دور المرشد التّربويّ في ضوء ما يواجه من تحديات وما يلزمه من احتياجات، وما يتوفر حقيقيّة على أرض الواقع، ومن تلك الحلول:
1-العمل على تطوير قدرات المرشد مهاراته وكفاياته عبر ديمومة التدريب، حيث الدورات الهادفة، وتبادل الخبرات مع الأطراف المختلفة.
2-متابعة المستجدات ومواكبة التّطورات التكنولوجيّة والتّربويّة والمعرفيّة...وتوظيفها في خدمة النشاطات والفعاليات الإرشاديّة.
3-التخطيط والتنسيق، والاستفادة من الإمكانات المتاحة: المادية، والبشرية؛ لما لذلك من دور في تحقيق المخرجات الايجابية: أكان على الصعيد السلوكيّ، أم التحصيليّ والمعرفيّ.
4-المرونة في التّعامل مع الأطراف التّربويّة، والسعي الدائم لتذليل العقبات لصالح العملية الإرشاديّة ومخرجاتها المختلفة.
5-الاستفادة من البرامج الإرشاديّة المعدة من قبل الوزارة وقسم الإرشاد التّربويّ في مديرات التربية والتعليم، وتوجيهها بما يتناسب وقدرات وإمكانات الطلاب، لأن نجاحها هو نجاح للمرشد، وفشلها يمكن أن ينتج عنه الكثير من التّداعيات السلبيّة.
6-الاهتمام بالسمات الشخصية للمرشد، والعمل على إيجاد المرشد القدوة في سلوكه وخبراته وتجاربه وألفاظه ومعارفه ومهاراته، والسعي الدائم لغرس معاني الثّقة والمسؤولية في نفوس الطلاب بشكل خاص، والأطراف التّربويّة الأخرى بشكل عام.
7-الاهتمام بالتّفريغ النّفسي للطالب، عبر المشاركة في ألعاب ترفيهية، أو من خلال توجيهه إلى ممارسة أدوار محببة له، من شأنها الحدّ من ظواهر التوتر والقلق والاكتئاب، التي قد تطرأ على الطالب خلال وجوده في المدرسة.
وقد ذهب بعض المشاركين إلى أنّ الضغوط التي يواجهها المرشد هي التي أسهمت في ابتعاده عن الدور المناط به، وتوجيه طاقاته نحو فعاليات وأنشطة لا تتناسب والأهداف الإرشاديّة التي وجد من أجلها، وهذه الضغوط تتعلق في بعضها بمزاجية التقييم، وبعدم تفهم المدير والمعلم لدور المرشد، وضيق الوقت، وكثرة البرامج الإرشاديّة، التي لا تتناسب وطاقات الطلاب وميولهم.
وفي ضوء تلك الاستنتاجات، ومن خلال استقراء ما حملته المقابلات من أفكار ورؤى وتصورات، فانيأرى ضرورةتطوير الكفايات والمهارات الإرشاديّة من خلال التّدريب المستمر، فضلًا عن ضرورة التّعاون بين الأطراف التّربويّة المعنيّة، لا سيما أنّ لكلّ طرف دوره المناط به، باعتباره يمثل حلقة في سلسلة، وبالتالي فإنّ أيّ خلل في تلك المنظومة يشكل خطرًا ليس فقط على الحالة التّعليميّة والتّحصيليّة والسّلوكيّة للطالب، بل يمكن أن يتجاوز ذلك ليشكل خطرًا على المجتمع ككلّ، لذا نصحت العينة بضرورة الاهتمام بالجانب الإرشاديّ؛ لما له من أهمية وضرورة في توجيه الطلاب،والإسهام في تحقيق أحلامهم وآمالهم، وهذا يقتضي تعاون وشراكة حقيقية حتى مع قسم الإرشاد والوزارة لما لذلك من أهمية، كما نصحت العينة بضرورة الاستفادة من خبرات بعض المرشدين، والاستفادة كذلك من البرامج الإرشاديّة التي تعزز هذا التوجه؛ الأمر الذي يقتضي الوقوف على ما يحمله كلّ طرف من مسوؤليات.
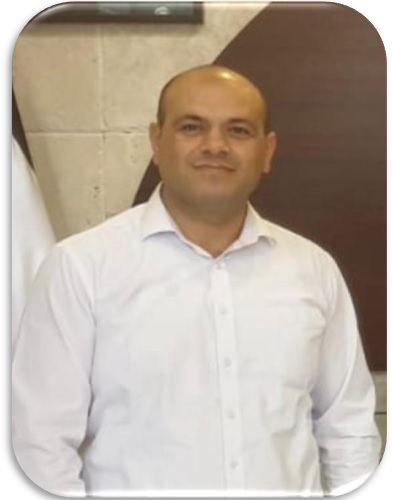
11/03/2021 11:34 1,016